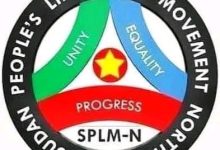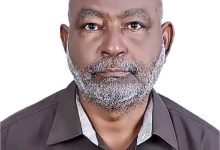القيادي بـ (تقدم) جعفر حسن:خطاب الكراهية يقود إلى تقسيم البلاد ويجب مقاومته
سودان ستار
القيادي بـ (تقدم) جعفر حسن:
المجموعات الإسلامية لديهم مشروعين للانفصال
حديث مساعد البرهان فيه نوع من “الليونة” تجاه السلام
حوار: أحمد خليل
حذّر رئيس الهيئة الإعلامية بالتجمع الاتحادي جعفر حسن، من خطر استشراء خطاب الكراهية الصادر عن غرفة واحدة تصدره إلى مجموعاتها بطرفي الحرب وجود مخططين لفصل السودان، منوهاً إلى دور )تقدم( في تدارك هذا الخطر ومقاومته بأدواتهم، وأشار حسن بحوار “سودان تايمز” معه إلى تحوّل أصوات من مربع دعم الحرب إلى مربع دعم السلام، و تطرق إلى المؤتمر التأسيسي لـ “تقدم” وجهودها في توسيع التنسيقية ودعم السلام و وحدة السودان..
*إرتفاع خطاب الكراهية والتصعيد من طرفي الحرب مع وجود تيار ثالث يدعو لوقف الحرب، ماهي السيناريوهات القادمة في ظل هذا الوضع..؟
توصيفنا للحرب هنالك معسكرين في السودان، معسكر للحرب ويشترك به كل من يدعو للحرب، ومعسكر يدعو للسلام، موقفنا نحن مع معسكر السلام، مسألة الناس مع الجيش أو الدعم السريع غير صحيحة، الصحيح مع الحرب أو ضدها وبناءاً على هذا هنالك عدد من المعارك، هنالك معركة بين الجيش والدعم السريع، وهنالك معركة أخرى بدأت تتشكل بين القوى المدنية الداعية للتحول الديمقراطي والقوى التي تعمل على توطيد النظم العسكرية في السودان، هنالك معركة بين القوى المدنية والمجموعات الإسلامية و الإرهابية، الخطاب الذي بدأ يتشكل كوقود للحرب أوجد معارك أخرى يراد بها الذهاب لمربع الكراهية والتقسيم وهذا سيفتت البلد، الخطاب خطر ولابد من مقاومته بشكل واضح وهذا يتطلب تشكيل جبهة عريضة ضده.
* مالذي تقوم به تقدم لمجابهة خطر التقسيم..؟
أحد أهداف (تقدم) الرئيسية تصلح أن تكون نواة لوحدة السودان بسبب وجود عدد من الناس المختلفين أتوا من جميع أنحاء السودان هنالك تمثيل من كل الجغرافيا والمستويات الثقافية والاجتماعية والدينية وهذا يعني الاجتهاد لإيجاد نواة تماسك الدولة من الانهيار، وهذه أهمية التحالف أكثر من الرؤية السياسية،هذا الوجود المختلف في ظرف مختلف لأجل السلام يجعل المشاركين مسامير ربط في مجتمعاتهم للدولة السودانية،يجب توسيع هذا الماعون لأكبر جبهة ممكنة، الترياق الحقيقي لمنع تفكك وحدة السودان هو قيام جبهة تمثل جميع السودانيين أو معظمهم.
* ماهي أدواتكم لوحدة السودانيين..؟
أهم مايماسك البلاد هو توصيف الحرب التوصيف الصحيح ونقلها من أنها حرب بين فئات جغرافية محددة ومكونات إجتماعية إلى حرب سياسية قادوها جنرالين تقودهم بدورهم مطامعهم ومطامحهم الخاصة وضغاينهم الخاصة لذلك تبعد من هذا التأثير ودوائر المجتمعات، الخطر أن يحدث انقسام إجتماعي حاد لا تستطيع إعادته مرة أخرى، وهذا ما تسعى له جهات عديدة في جميع الأطراف المتقاتلة، وهنالك مجموعة خطابها الأساسي مبنى على هذه المسألة وكثير ماينتابني الشك بأن هنالك غرفة مركزية واحدة ترسل خطاب الكراهية للمجموعة “أ” والمجموعة “ب” بطريقة مختلفة، ودورنا الأساسي أن نهدم هذا الخطاب.
*كيف نهدم خطاب الكراهية..؟
بأن نقدم الخطاب البديل وهو الوعي وأن المجرم لا قبيلة له، لابد أن ننشر الوعي بهذه الحرب ومسبباتها والمستفيد منها وإلى أين يمكن أن تقودنا ونبصرهم ونبشرهم بمستقبل الدولة السودانية الموحدة، السودان له تجربة انفصال، ولذات الخطاب انشئت صحف كان تخصصها أن تعمل على فصل جنوب السودان، وكان هنالك خطاب عدائي وكراهية، و بالانفصال لم يستطع الجزء العزيز الإنطلاق ولا استطاعت الدولة الأم التوازن، الآن يعاد نفس السيناريو مع دارفور بنفس الخطاب وذات الجهات وجهات أخرى، قبل يومين سمعت خطاب لأحد قادة المؤتمر الوطني لضم شمال السودان لدولة أخرى وهذه قمة الخيانة والمضي في تفتيت الدولة السودانية، لابد من تحديد المستهدفين الوحدة ودراسة خطابهم بشكل واضح، لابد من تقديم الحلول، لابد من استعجال إيجاد حل للحرب لأن إطالة أمد الحرب الانفصال في النهاية يحدث يأس من فكرة الوحدة وهنالك تعبئة كبيرة جداً للنفوس وهذا تعمل عليه المجموعات صاحبة المصلحة في الانفصال وهي بالتحديد المجموعات الإسلامية ولديهم مشروعين للانفصال ويعملون عليهما مشروع دولة البحر والنهر، وهذا يضم الشمالية ونهر النيل وكسلا و القضارف والبحر الأحمر وشمال كردفان والجزيرة والنيل الأبيض وهنالك مشروع أخطر ضم الشمالية ونهر النيل لدولة أخرى وهذا ليس اتهام بل قيل في تصريحاتهم وبالنسبة إلينا وحدة السودان خط أحمر وعندما تتفتت الدولة إلى دويلات وتتحالف مع بعضها البعض وهذا يعني الانقسام مع استمرار الحرب مع وجود حروب داخلية لكل دولة بين مكوناتها المختلفة .
* لماذا صوتهم أعلى ..؟
مسألة الصوت مرتبطة بعدد من العوامل لأن الحرب معقدة جداً ، واحد من العوامل القدرات المالية المسخرة لهذه المجموعة وهي مبالغ ضخمة ، في حالة الحرب الناس يسعون لسماع خطاب الأمانى وليس الحقيقة، وهم يقدمون خطاب الأمانى والتطمينات، الخطاب الشعبوى الذي تغيب فيه الحقيقة وتعطل مصادر المعلومة المحايدة، وأصبح الصحفيين الآن في السودان بين داعم للجيش وداعم للدعم السريع على حسب منطقة وجودهم أو تخفى أو تخففها على حسب خطورة المعلومات، لذلك الخطاب المتزن العاقل احتمالية وجوده أضعف لكن بطبيعة الحروب الخطاب الشعبوى الرغبوى لن يستمر كثيراً وتبدأ تتكشف الحقائق وتجد حالياً موقف الناس من الحرب في بدايتها يختلف الآن والخطاب العاقل يحتاج إلى خطة مُحكمة وتطوير آليات لمواجهة خطاب الحرب ، الآن قاعدة إيقاف الحرب كبيرة فهنالك مجموعات كانت داعمة للحرب ومعروفة الآن أصبحت تخرج مبادرات لإيقاف الحرب وبالأمس كان خطاب مساعد البرهان ياسر العطا وكان فيه نوع من الليونة حيث قال لا بديل لمنبر جدة وتلقائيا هى عودة من منبر لا تفاوض ولا حوار إلى الاعتراف بمنبر جدة إذن الفكرة لعودة التفاوض، لكن إذا سألناه كم فقدنا من الأرواح منذ أن قال لا للتفاوض وكم فقدنا من المؤسسات وعدد النازحين وغيرهم من متضرري الحرب، لذلك المكابرة لم تكن لها معنى ولن يصح إلا الصحيح وهو إيقاف الحرب عبر التفاوض، وهذا هو الموقف العقلاني الصحيح، ومن هنا أشدد على ضرورة الترحيب من الجميع لكل العائدين من مربع دعم الحرب إلى مربع دعم ايقافها، الحرب ستقيف عندما تفقد مشروعيتها عند المدنيين والمواطنين، عندما يتفق المواطنين على لا للحرب لن يقاتل الجندي لأن الدافع الأساسي للجندي سواء كان في الجيش أو الدعم السريع هو اعتقاده أنه يدافع عن المواطنين، لا للحرب ستفقد الحرب مشروعيتها و وقودها.
*بالنسبة للقوى السياسية التي لم تنضم لتقدم ماذا قدمتم لهم؟
الحوار لم ينقطع مع كل المجموعات وكانت كثيرة، الآن حدث اختراق كبير من (تقدم التأسيسي)، الحركة الشعبية ستحضر كمراقب وكذلك المؤتمر الشعبي والاتحادي الأصل، وهذا بمثابة فتح مساحات زيادة غير المجموعات الكبيرة التي انضمت، تبقت لنا بعض القوى السياسية المهمة كحزب البعث العربي الاشتراكي الأصل والحزب الشيوعي السوداني، وكذلك حركة عبد الواحد محمد نور، يمكن أن نجد صيغة حتى ولو من باب التنسيق في الموقف العام لإيقاف الحرب نعملها مع بعض وسنرى ماذا سيقول المؤتمر حيالها، لكني اوكد لا غنى عن أي سوداني أو أي صوت يعمل على إيقاف الحرب وإحدي التحديات وجود جبهة واحدة رافضة للحرب.