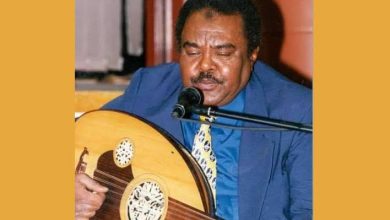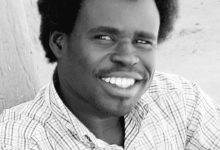رسالةٌ..
في ذكرى محمد يوسف: ما بين “بدور القلعة” و”الحالم سبانا” ضلّ مولاي ابن الفارض
صديقنا مريود، القاصُّ بديعُ الحكي،
هذا المساء أكتب لك تداعياتٍ جاءت كما هي، وردَ الخاطر، وظني بها أن تكون حقيقةً بالتأمل، تسيّدها حبيبنا الذي لا يأتي إلا مع كل تالدٍ ولطيف:
“*وهوى الغادةِ عمري عادةً*
*يُجلبُ الشيبَ إلى الشابِّ ألاُحَيْ”*
هذا هو بيت مولاي ابن الفارض، الذي كنتُ “أكوسه”، بعد أن حلّ الشيب بي، ففضّلت أن أكون حليق الرأس دوماً، ولا أرجو منهن ودًّا لمظهر. و”الأُلحَيْ” تعني من كان سواده يضرب إلى خضرة، وقد توطّن عند الشعراء الفحول أن الغرام يعجّل بالكهولة وملحقاتها من شيبٍ وطمسٍ لعلامات الشباب و”دغمسة” العيون:
“*العيون النوركن بجهرَا*
*غيرَ جمالكن مِين السهرا”*
هكذا كان رد “أبو صلاح” على مقالة غادة القلعة: (أبو صلاح، أبو صلاح أب عيونن دقاق دا).
ونعود لظريفنا “محمد يوسف”، رضي الله عنه، وقد اقترن عندي بذكر مولاي ابن الفارض، فهو كان دائم الترجيع لقوله:
ما بين ضالِ المنحنى وظلالِهِ
ضلّ المتيَّمُ واهتدى بضلالِهِ
يرجّع ذلك بصوتٍ رَخيمٍ هامسٍ، يحمل لك معناه الرقيق، وهو “متوهِّط” على “بنبر” الشاي، مادٌّ عنقه، مباعدٌ بين فخذيه، ممدودٌ إليك كلُّه، كأنما يُجهد أن يشمّ وقع مقاله في عينيك.
هكذا كان صديقي شغوفًا بكل ما احتضنت عاقلته من نعيم كلامٍ وقصيدٍ ونثرٍ وحكاية، لا يمكث عنده إلا نافعٌ وطريفٌ ولطيف.
ومعنى بيت مولانا ابن الفارض من مواتع التصوف وعميقه، لا يكتنه دلالاته إلا صاحب قدمٍ في العرفان. وشرحه من شرح، وتقاصر عن بعيد معناه ومطويات صوره وجماله.
البيت مدخلٌ لقصيدٍ يهتدي بطرائق القدماء في الوقوف على الآثار والأمكنة التي تهيج الكوامن. وفي معناه اللغوي، نجد أن “بين” ظرف مكانٍ،وَزَمَانٌ أَيْضًا، وفي سياق البيت منصوبٌ متعلقٌ بـ”ضالّ”، وذلك من لطيف معنى مقال شيخنا.
و”الضال” نوعٌ من شجر السدر، و”المنحنى” موضع، و”الضلال” خلاف الهدى. وأن تهتدي بضلالك شيءٌ معروفٌ عند أهل التصوف، فالله إذا أحبّ عبدًا من خلقه، “يسوقه” إليه بحاجته، أي بحاجة العبد التي يريد، ضالّته أو ضلاله.
وقد خرج موسى بعد أن قتل نفسًا، فوجد بعد رحلةٍ عند النار هدى، وخلع نعليه.
البيت في خلاصته عرفانٌ يجمع بين مقام السدرة والفناء: انمحاء العبد في جلال الرب.
ويقال: ضلّ الشيء في الشيء، أي غاب فيه، وضلّ الماء وأضلّه أجراه بين الصخور والأشجار.
وهكذا سيدي “محمد” أصبحت ذاتُ مولاي ابن الفارض، بعد أن بلغ مقام السدرة للكمّل، هي ذات “ليلى”، فعرف نفسه وعرف ربّه.
والصورة مأخوذة بتمامها من قوله تعالى:
*”إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى * مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى”*
بتأويل المتصوّفة، لا بقراءة أهل الظاهر، ولا الظاهر المتأوَّل حتى!
ولمحمد جميلةٌ أخرى من لطائف قصيد المغنى: “الحالم سبانا”، يغنيها بصوته الداودي ذاك (أعني عبد العزيز داود، لا داود النبي المزمار)، ويقهقه، ثم يحكي لك عن شاعرها ود القرشي، محمد عوض الكريم القرشي، وعن عبقريته في حمل الجمال الذكوري إلى مصافٍ يرتقي لما بعد أنوثة بدور القلعة، وعن كيف يدس القرشي اسم فاتنه الملازم أول، في حوامل المعنى.
ثم يعود، رضي الله عنه، يغني مرة أخرى “الحالم سبانا”، ويتوقف ليقول:
عليك الله يا مرغني، شوف الزول دا، دا جن عديل:
تأمّل فيهو مرّة
وشوف دلّ العذارى
تجد الصورة تحلف
يوسف في إطارها
اللألاءة عيونو
والبيضاء سنونو
كم يُغريك ثغرو
كم يسبيك سحرو
هالِكنا الأمير
ولكن…
لماذا رحل محمد يوسف باكرًا؟
لماذا؟
أستغفر الله العظيم.